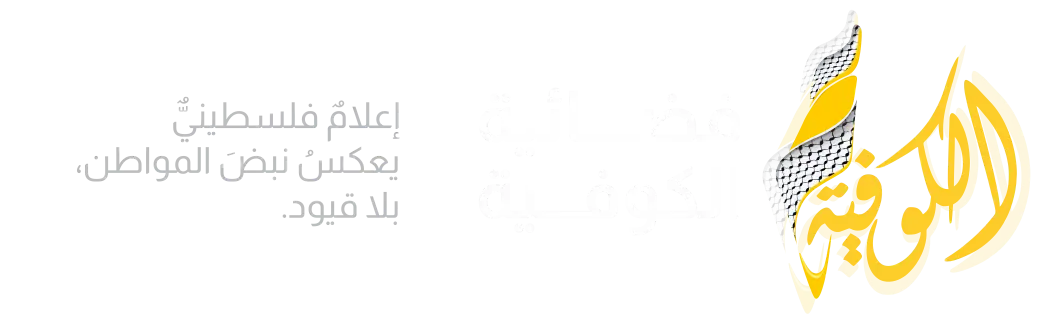حماس والإسلاميون في زمن الإبادة: أسئلة المراجعة وحدود الممكن

د. أحمد يوسف
حماس والإسلاميون في زمن الإبادة: أسئلة المراجعة وحدود الممكن
الكوفية في أعقاب معركة «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة فحسب، بل تكشّفت، على نحو غير مسبوق، حدود النظام الدولي، وانكشفت زيف كثير من المسلّمات السياسية التي حكمت مقاربات الصراع لعقود طويلة.
فالنكبة الإنسانية والسياسية التي أعقبت المعركة لم تكن حدثًا معزولًا، بل نتيجة تراكم ممتد من الإخفاقات والرهانات الخاطئة، وعجز عربي ودولي عن كبح مشروع استيطاني إحلالي لا يعترف بحدود ولا يقيم وزنًا لقانون أو شرعية. وفي هذا السياق، يصبح من غير المنطقي مطالبة الفلسطيني، أو فصيل بعينه، بمراجعات سياسية عاجلة، من دون الاعتراف بأن ما يجري هو حرب وجود، لا أزمة تكتيكية عابرة، يخوضها الفلسطيني في ظل اختلال صارخ في موازين القوى، وغياب شبه كامل لأي حماية دولية.
لقد عاد سيناريو التهجير القسري ليطفو على السطح بوصفه خيارًا واقعيًا في الخطاب السياسي الإسرائيلي، لا مجرد تهديد دعائي. ولم يكن لهذا أن يحدث لولا الغطاء الأميركي المفتوح، الذي لم يقتصر على الدعم العسكري، بل وفّر شرعنة سياسية وقانونية للإبادة، وأعاد إنتاج خطاب استعماري قديم يرى في فلسطين «أرضًا بلا شعب»، وفي الفلسطيني عبئًا ديمغرافيًا يمكن التخلص منه.
في هذا المناخ، لم تُشيطَن المقاومة الإسلامية فجأة، بل جرى توظيفها ضمن معركة أوسع تستهدف تجريد الفلسطيني من أي أداة للدفاع عن نفسه. فقدّمت إسرائيل حركة حماس، ومن خلفها الإسلاميين، بوصفهم خطرًا إقليميًا شاملًا، لا حركة تحرر وطني، وساعدتها في ذلك أنظمة عربية اختزلت القضية الفلسطينية في بعدها الأمني، لا باعتبارها قضية تحرر وعدالة، بل ملفًا مزعجًا قد يهدد استقرار أنظمتها.
غير أن جوهر الإشكال لا يكمن في صورة حماس لدى هذه الأنظمة بقدر ما يكمن في العقيدة الأمنية العربية التي تشكّلت خلال العقود الأخيرة، وجعلت من حماية النظام أولوية مطلقة، حتى لو كان الثمن تحييد الصراع مع إسرائيل أو احتواء الفعل الفلسطيني. ووفق هذه المقاربة، لم يعد يُنظر إلى أي فاعل مقاوم بوصفه رصيدًا استراتيجيًا، بل خطرًا محتملًا، بغضّ النظر عن هويته الأيديولوجية.
من هنا، تبدو الدعوات إلى «طمأنة الأنظمة» أو إعادة التموضع داخل ما يُسمّى «الحاضنة العربية» دعوات ناقصة، ما لم يُعترف بأن هذه الحاضنة نفسها تعاني أزمة بنيوية عميقة، وأنها في كثير من الأحيان لم تعد وسيطًا داعمًا، بل طرفًا ضاغطًا يسعى إلى تحييد الفعل الفلسطيني أو توظيفه كورقة تفاوض.
ومع ذلك، فإن هذا الواقع لا يعفي حركة حماس، ولا الإسلاميين عمومًا، من مسؤولية المراجعة. غير أن المراجعة المطلوبة ليست اعتذارًا عن المقاومة، ولا تنصّلًا منها، بل إعادة تعريف دورها ضمن مشروع وطني جامع، يوازن بين الفعل المقاوم وحدود السياق الإقليمي والدولي، من دون الوقوع في وهم أن السياسة وحدها قادرة على انتزاع الحقوق في مواجهة استعمار استيطاني لا يفهم إلا لغة القوة.
لقد أثبتت التجربة أن المسار السياسي الفلسطيني بصيغته التفاوضية التقليدية وصل إلى طريق مسدود. ثلاثون عامًا من الرهان على «حل الدولتين» لم توقف الاستيطان، ولم تُنهِ الاحتلال، ولم تمنع الإبادة. ومن ثمّ، فإن أي حديث عن تفعيل العمل السياسي والدبلوماسي يجب أن ينطلق من مراجعة جذرية لهذا المسار، لا من العودة العمياء إليه.
في المقابل، يشهد الرأي العام الدولي، ولا سيما داخل المجتمعات الغربية، تحوّلًا متزايدًا، حيث بدأت الرواية الصهيونية تفقد احتكارها الأخلاقي. وهذا التحول لم يكن ثمرة الدبلوماسية الرسمية، بل نتيجة صمود الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال، واتساع دوائر التضامن الشعبي، بما في ذلك أصوات يهودية مناهضة للصهيونية، وحركات يسارية أعادت تعريف الصراع بوصفه قضية استعمار وعنصرية.
إن الاستثمار في هذا التحول واجب وطني، من دون تفريغ المقاومة من مضمونها أو اختزالها في أداة رمزية. فالمقاومة ليست نقيض السياسة، بل شرطها في سياق الاحتلال. والجدل الحقيقي ليس بين السلاح والسياسة، بل بين مشروع وطني جامع ومقاربات مجتزأة.
في الخلاصة، ليست القضية الفلسطينية أزمة خطاب ولا خلافًا فصائليًا، بل صراع وجود مع مشروع إحلالي مدعوم دوليًا. والمطلوب اليوم ليس خفض سقف الحقوق، بل توسيع أفق الرؤية، وبناء مشروع وطني قادر على الجمع بين المقاومة، والسياسة، والتحالفات، مع الحفاظ على جوهر القضية: التحرير، والعدالة، وحق الفلسطيني في الحياة على أرضه.